قصة التنوير الإسلامي المنسية

يريد المؤرخ والصحفي البريطاني كريستوفر دي بيلايغيو من خلال كتابه "التنوير الإسلامي: الصراع الحديث بين الإيمان والعقل"، أن يؤكد بأن التنوير حقبة عرفها العالم الإسلامي، إذ يعرض الكتاب باستمرار لسياسة "الحركات الإصلاحية" في مراكز الثقافة الإسلامية الثلاثة، في القاهرة واسطنبول وطهران، والتي وجدت نفسها مضطرة منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى التعلم من الثقافات الأوروبية المجاورة، حتى تستطيع الصمود أمام هؤلاء الجيران.
"تعلموا من ثقافتنا ولم يصبحوا مثلنا"
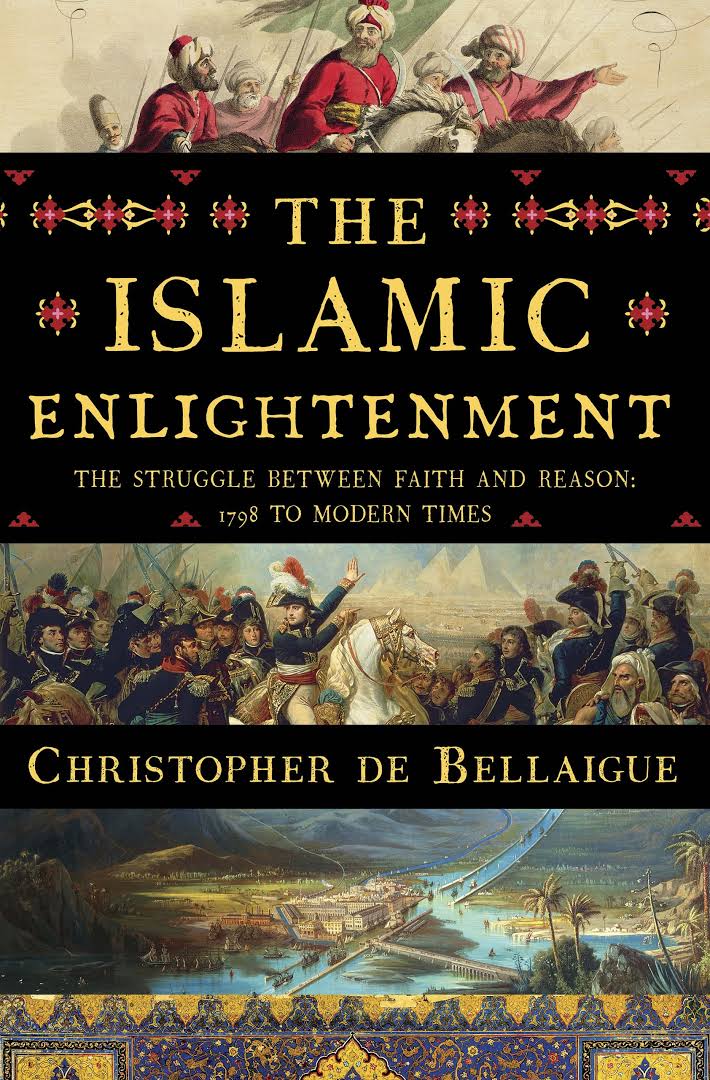
لكن دي بيلايغو يأتي برؤية جديدة. إذ، وحتى اليوم، ما زال يتم وصف ذلك "الإصلاح" فقط من طرف أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مالكي وصناع إنجازات التنوير. إنهم يصفون كيف تعلمت الثقافات الأخرى من ثقافتنا. ومن وجهة نظرهم، ظلت صيرورة التعلم هذه جديرة بالتقدير ولكنها لم تكتمل، فهم لم يستطيعوا أن يصبحوا مثلنا، ورغم أنهم حاولوا بجد التعلم منا. وهنا يتم التأكيد دائما على أنهم ـ أي تلامذتنا في الشرق ـ "يقتربون" منا، ولكنهم لم يحققوا الهدف كله، هؤلاء الذين سيظلون تلامذتنا ومقلدينا.
ينجح دي بيلايغو، الذي عمل مراسلا في الشرق الأوسط لصحيفتيْ غارديان وإيكونومست" في وصف التطور، الذي عرفه العالم الإسلامي من وجهة نظر فاعليه، وهو يوضح في البداية ماذا كان يعنيه للعرب والأتراك والإيرانيين في القرن التاسع عشر اللقاء بالثقافة الأجنبية. كما يؤكد كيف تمت تبيئة ثقافة هذا الأجنبي ونمط عيشه في المنطقة.
تقول أطروحته الأساسية إن العالم الإسلامي قد عاش فعلا حقبة تنويرية. وطبعا، فقد تم تبني المثالات الغربية، لكن الكاتب يسلط الضوء على عمل التبني هذا، وعلى إنجازات الشخصيات الشرق ـ أوسطية كمنورين لمجتمعاتهم وليس على وضعية أن فعل تبني الثقافة الأجنبية لا يمكنه أن يكون كاملا بالضرورة، مقارنة بما يحدث في أوروبا.
وإلى حد الآن، تم النظر إلى التنويريين في الشرق الأوسط، مثل رفاعة الطهطاوي (1801ـ 1873) والإيراني ميرزا صالح (1790ـ 1840)، والذي زار بريطانيا ووصفها، والتركي ابراهيم سيناسي (1825 ـ 1871)، والذي لعب دورا حاسما في تبني التركية الحديثة كلغة للتداول وتأسيس أول صحيفة تركية، كمجرد وسائل لنقل الثقافة الغربية إلى الشرق. ولقد حدث الشيء نفسه مع آخرين أيضا.الكتاب الجديد يسلط الضوء عليهم كمنافحين عن الثقافة الجديدة، والتي من شأنها أن تساعد على إعادة تشكيل ثقافاتهم القومية.
ويؤكد صاحب الكتاب بأن هؤلاء الإصلاحيين قد نجحوا بالفعل في تحقيق تحول كبير داخل المجتمعات الاسلامية التقليدية، وبدلا من الادعاء بأنهم "أصبحوا تقريبا مثلنا"، يجري الحديث عن "أنهم وجدوا قيما يريدون تبيئتها داخل مجتمعاتهم، ومن شأنه ذلك أن يغيرها من الأساس وباستمرار".
العين الأوروبية التي تبصر بالثقافات المجاورة، ترى حتى يومنا هذا الاختلافات: "هذا وذاك مختلف عما عندنا. رغم كل الجهود التي بذلوها للتعلم منا". فالعين الشخصية تنظر إلى تغير الزمن، وكيف تغيرت الثقافة الوطنية نتيجة لجهودنا، بشكل كامل، "فلا شيء ظل كما كان عليه الحال في الماضي!".

دي بيلايغيو تمكن -بفضل قدرة لا تضاهى على النفاد إلى الثقافة الإسلامية- من أن ينظر إلى ذلك التحول بأعين أصحابه، الذين عمدوا إلى تنوير مجتمعاتهم التقليدية، بدلاً -كما كان الحال في كل العروض السابقة- من أن يتم الحديث، مع الأوروبيين أو غيرهم، وبشكل إيجابي أو سلبي عن "التغريب".
التنوير الإسلامي يقف أمام مأزق. وحتى هذا الوضع يعمد مؤلف الكتاب إلى عرضه، ولكن بشكل أقل تفصيلاً مقارنة باهتمامه بالمرحلة التنويرية.
الأزمة تبدأ مع الحرب العالمية الأولى، والتي أجهزت على الامبراطورية العثمانية، وما نتج عن ذلك من تقسيم للعالم العربي بين القوى الاستعمارية، أو ما يعرف اختصارا بمعاهدة سايس بيكو، ولكن أيضا قيام دولة تركية قومية وإيران قومية بقيادة بريطانيا ولاحقا الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد ظهر التناقض بين قيم الحرية التي ينافح عنها الغرب وسياساته التي تهدف إلى استعباد الحضارات المجاورة. فالإكراهات التي رافقت التنوير، هذا التنوير الذي يقوم على الأمر وعلى خدمة من يصدر الأوامر، تسمح للمحافظين -أعداء التنوير الذين لم يخلُ زمن منهم- بأن يسيطروا على الوضع وأن يفقدوا التنوير مصداقيته.
"الحقبة الليبرالية" تصل إلى نهايتها. فتكنولوجيا السلاح خصوصا والمصانع ما زالت تعتبر ضرورية. وبدونها لا يتحقق شيء. لكن الجيران الغربيين توغلوا بشكل كبير يتجاوز كل مقاومة. وها هم العسكر يُقدِمون على السيطرة على السلطة بعد تراجع القوى الاستعمارية عقب الحرب العالمية الثانية.
ولكن واقع أنهم وجدوا من الضروري تكوين برلمانات -ولو صورية- يظهر بأن العالم التقليدي قد تغير. لكن الضغط المتواصل للأجنبي سوف يدعو لبذل المزيد من الجهود. فقد غلبت المحاولة التنويرية الرامية إلى مواءمة المجتمع مع المعايير العقلانية على المشروع القومي.
فالهدف من وراء ذلك كان تحقيق سلطة أكبر للمجتمع في ظل مفهوم الأمة القومية المستورد. ولهذا تطلب الأمر قيادة عسكرية.
ومع خفوت نجم الأنظمة العسكرية بسبب انهيار الآمال التي علقت عليها وخسارتها في الحروب، ارتفع النداء للعودة إلى الأصول "الإسلامية". وكان أول من عبر عن ذلك هي حركة الإخوان المسلمين والتي تأسست عام 1928، وبعدها من طرف جناحها الراديكالي، والذي كان تحت تأثير سيد قطب، الذي أعدمه جمال عبد الناصر عام 1966.
ويصف المؤلف هذا التطور بتفصيل، مبرزا الموتيفات والأسباب الكامنة خلفه. كما يسلط الضوء على النتائج المترتبة عن ذلك والمتمثلة في ظهور إسلام لا علاقة له بالفهم السابق للدين، ولكن يهدف بالأساس إلى طرد الأجنبي، وهو أمر يتحقق بسرعة، إذا ما عمد هذا الأجنبي للتدخل عسكريا في المنطقة كما حدث في أفغانستان والعراق.
ولكن حتى في البلدان التي لم تشهد غزوا عسكريا غربيا، من إيران وحتى المغرب، فإن هذه الرؤية الجديدة ستعرف انتشارا، وستجد في الإسلام حصنا ضد تسلل الأفكار الغربية ووسيلة لحشد القوى ضدها. وفي الوقت نفسه نقف على أغلبيات مسلمة تأمل بالعودة من جديد إلى الطريق الذي بدأته قبل مائتي عام ومواصلته باتجاه مستقبل أكثر تنويرا.
أرنولد هوتينغَر
حقوق النشر والترجمة: موقع قنطرة 2018
كاتب المقال أرنولد هوتنيغر من أهم المتخصصين في الشرق الأوسط، عمل لعقود كمراسل لصحيفة "نويه تشوريشه تسايتونغ" في بيروت ومدريد وقبرص. وصدرت له كتب كثيرة حول العام الإسلامي، منها "الدول الدينية وهرميات السلطة: الديمقراطية في العالم الإسلامي" (2000) وَ "العالم الإسلامي: الشرق الأوسط: تجارب، لقاءات وتحليلات" (2004).