في استحالة الدولة الدينية وضرورة الدولة المدنية
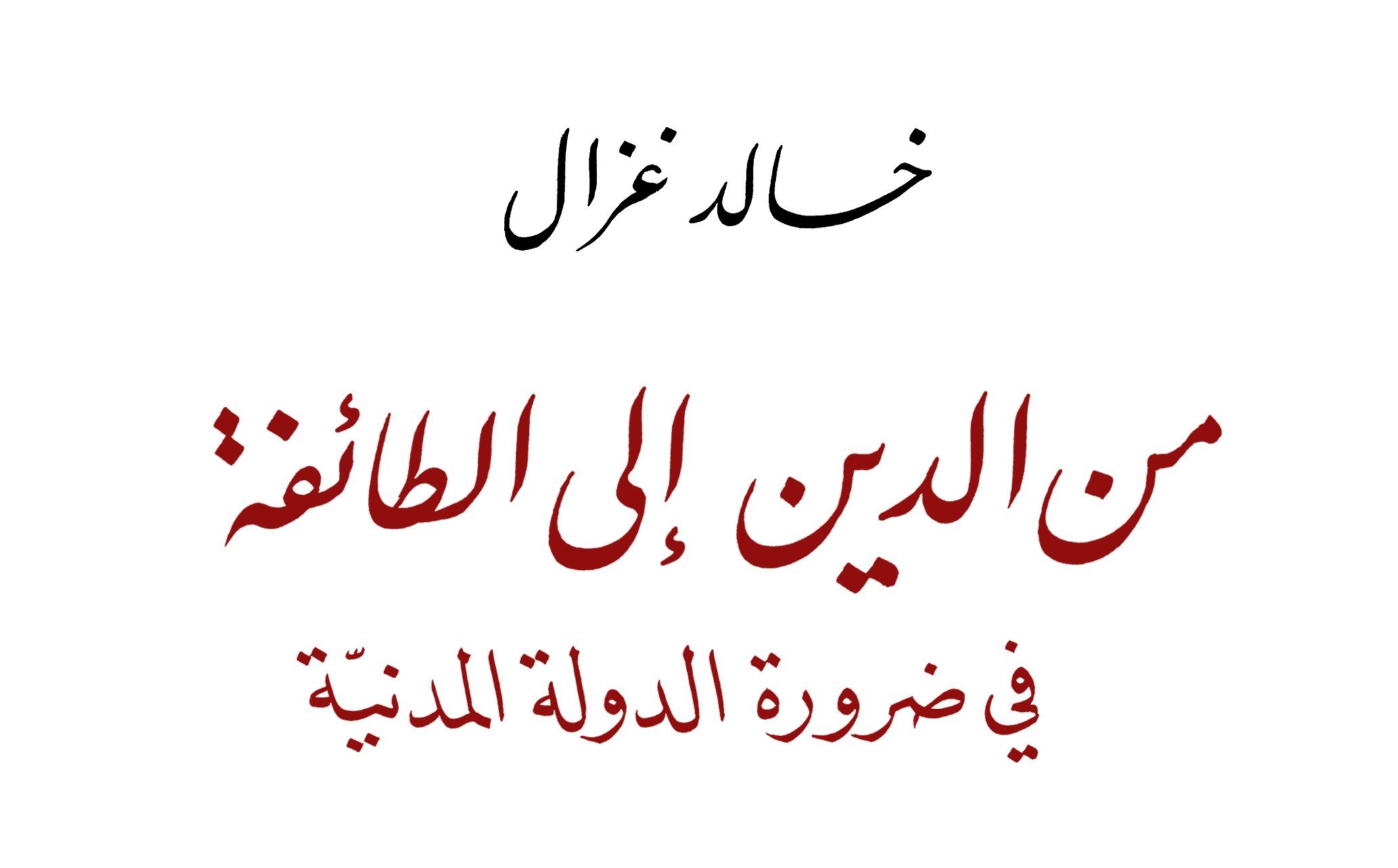
هل الحركات الإسلامية التي تتجلبب بجلابيب طائفية ومذهبية تعبّر فعلاً عن أهداف الدين ومقاصده النبيلة أم أنها في جوهرها ومراميها حركات سياسية متلبسة زوراً بلبوس الدين؟ هل يعود العنف المصاحب لهذه الحركات إلى بنية الأديان، وهل الابتعاد عن الدين ورفضه يمنع المجتمعات من الانزلاق إلى العنف؟ وكيف السبيل إلى تجاوز الانقسامات التدميرية الراهنة التي تهدد المجتمعات العربية اليوم وتنذرها بسوء المصير؟
أسئلة إشكالية مربكة جهد خالد غزال في الإجابة عليها في كتابه "من الدين إلى الطائفة، في ضرورة الدولة المدنية" (دار الساقي - بيروت 2015)، من منحى عقلاني تميز بالرصانة والجدية فكراً ومنهجاً ولغة، حيث تصدى من ناحية للاتهامات والتفسيرات المغرضة للأديان، فيما طرح من ناحية أخرى رؤية ليبرالية حداثية لتجاوز النزاعات الدموية والشروخ الطائفية وبناء مجتمع عربي قوامه العدل والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان.
في رأي المؤلف أن ما تمارسه المذاهب والطوائف من اقتتال وبناء للكراهية بين أبناء الدين الواحد، أو بين الأديان المتقابلة، لا يصب مطلقاً في خانة الجوهر الأصلي الذي قامت عليه الأديان.
هذا التوظيف للدين هو المسبب الرئيسي للنزاعات الدينية التي تجري اليوم في العالم، وإذا كانت أوروبا قد دفعت مئات آلاف الضحايا من أجل إبعاد الدين عن السياسة، فان المجتمعات العربية والإسلامية تقدم اليوم مشهداً أقرب إلى المشهد الأوروبي في القرنين السابع والثامن عشر. إلا أن الأخطر في الأمر اعتماد الحركات الأصولية الإرهاب طريقاً أساسياً في عملها وتوظيف النص الديني في خدمته، ثم تقديم مشاريعها للسلطة بوصفها تطبيقاً للشريعة وتمهيداً لبناء الدولة الدينية.
يؤكد غزال أهمية العامل الديني بوصفه عاملاً تاريخياً يحتاجه كل مجتمع كما تحتاجه الذات البشرية نفسها، وما أتت به الأديان التوحيدية كان في معظمه امتداداً لتراث ديني غني قدمته البشرية منذ فجر تاريخها. ومن هنا يجب التمييز في الدين بين ما هو أبدي يتجاوز الزمان والمكان وبين ما هو متبدل ومتصل بالزمان والبيئة المحددة وكيفية التعبير عنها في تاريخها المحدد، وهو ما يتعلق منها بالتشريعات والطقوس والأحكام، وكلها أمور تخضع في كل مرحلة إلى درجة تطور المجتمع وتقدمه، ما يشكل الأساس لفهم التعدد الديني وبلورة الإصلاح الديني المنشود.
وإذ يطرح المؤلف مسألة الانقسامات بين الأديان التوحيدية وسلوكها سبيل العنف، يلاحظ أن العنف من أقدم الظواهر في تاريخ البشرية، وقد كان قبل الأديان التوحيدية واستمر معها وتصاعد في المجتمعات الحديثة إلى درجة تدميرية، على رغم أن الأديان التوحيدية يغلب على نصوصها الدعوة إلى المحبة والرحمة والعدالة وغيرها من القيم الروحية. واذا كانت الكتب المقدسة تحوي نصوصاً تدعو الى العنف، فهذه النصوص يجب ان تقرأ في سياقها التاريخي وفهم اسباب ورودها، وعدم التعاطي معها باعتبارها ذات صفة راهنية، مما يبرر استخدام العنف ويعطيه مشروعية.
اقرأ/ي أيضًا: كتاب "مفهوم الدولة الإسلامية: أزمة الأسس وحتمية الحداثة"
"الدولة الإسلامية" كانت نتاج الضرورات التاريخية وليس النصوص العقدية
ملف خاص من موقع قنطرة حول التاريخ الاسلامي
محمد أركون: الوعي التاريخي مفقود في ثقافتنا العربية المعاصرة
الطائفية نقيض الديمقراطية...حرب البربريات في العالم العربي
حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيرت مثالا
ما يشهده الإسلام اليوم من تأويلات تشرع العنف في افظع مظاهره، عرفته المؤسسة الكنسية في القرون الوسطى بكل ما نجم عنه من مظاهر غير إنسانية ومجازر وحروب أودت بالملايين، من محاكم التفتيش المرعبة وفنون التعذيب الإجرامية، الى الحروب الصليبية التي وظفت الدين في السيطرة على سائر الشعوب. بدوره عرف الإسلام عبر تاريخه أشكالاً من العنف، إن في الفتوحات التي قامت باسم الدين أو في حروب الردة وحروب الخوارج أو في الاغتيالات التي طاولت ثلاثة من الخلفاء الراشدين. ومن هذه الأشكال ما يحاكي فنون التنكيل في القرون الوسطى المسيحية، من الضرب والجلد وتقطيع الرؤوس والأوصال، إلى سلخ الجلود والحرق.
وفي كل ذلك في رأي المؤلف دلالة على استحالة قيام أو وجود دولة دينية يقودها رجال الدين وتطبق القيم الدينية وتنشر العدالة والمساواة بين البشر. فالمسار الدموي الذي انخرطت فيه المجتمعات المسيحية والإسلامية على السواء يؤكد استحالة أن يكون الدين عنصر توحيد وطني في أي مجتمع من المجتمعات. وإذا كانت اليهودية قد حققت أسطورتها عبر قيام دولة إسرائيل، إلا انه لا يوجد في قانون هذه الدولة أي إشارة إلى الشريعة اليهودية كمصدر للتشريع، والحكم فيها يقوم على المواطنية، كما لا يعطي القانون الحاخامات أية سلطة في التشريع أو اختيار الحاكم بل يتساوى هؤلاء وسائر فئات الشعب، وقد تحول المجتمع الذي أراده الصهاينة موحداً مجتمعاً متعدد الثقافات والطوائف.
وما يصح على الدولة اليهودية يصح كذلك على الدولة المسيحية، فقد باءت بالفشل كل محاولات الأساقفة لفرض سلطة الكنيسة على المجتمعات المسيحية، بل كان هناك ما يشبه التواطؤ بين الكنيسة والسلطة الزمنية، فتقدم الكنيسة المشروعية الدينية للسلطة فيما تساعد السلطة الكنيسة على فرض لاهوتها على المجتمع.
وعلى رغم أن التاريخ الإسلامي والعربي لا يثبت فعلياً أن دولة دينية قد تحققت في يوم من الأيام، وان فكر التيارات الإسلامية في هذا المجال ليس اكثر من كلمات تؤجج الوعي الإسلامي وتحشد الجماهير في الصراع السياسي، إلا أن هذا لا يعني أن الشعار لم يكن من دون أساس في التاريخ، فقد كان ثمة تواطؤ بين النظام السياسي والمؤسسة الدينية من العهد النبوي الى العهد العثماني.
في رأي المؤلف ان مفهوم الدولة الدينية هو مفهوم حديث، ولا يوجد في الفكر الاسلامي اي مفهوم للدولة، كما ليس في القرآن اي حديث عن السياسة كما هي اليوم. لكن الاخوان المسلمين سنداً إلى أبي الأعلى المودودي قالوا بالدولة الدينية وبالحاكمية الإلهية، وان لا مجال في الإسلام إلا لدولة يقوم فيها المرء بوظيفة خليفة الله. إلا أن علماء مسلمين كباراً مثل علي عبد الرازق ومحمد عبده نفوا أن يكون الإسلام قال بالخلافة ووجوبها، ورأوا أن الإسلام ترك للشعوب أن تحدد نظامها انطلاقاً من المحددات السائدة في زمنها.
وعليه أن الإسلام لم يعرف دولة دينية في تاريخه، فتاريخ الخلافة هو تاريخ لنظام سياسي في مرحلة محددة لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد والرؤيا الدينية التي شكلها عنها الفقهاء لا ينبغي أن تحجب الطابع الدنيوي المحض للسلطة السياسية في الإسلام.
إن استحالة الدولة الدينية أو بناء دولة حديثة استناداً إلى الانتماء الديني يجعل الدولة المدنية ضرورة ملحة في المجتمعات العربية. ويحدد المؤلف مكونات هذه الدولة بالمواطنة والفصل بين الدين والدولة واعتبار الشعب مصدر السلطة. أما الديموقراطية فيجب أن تتأسس على القيم الليبرالية التي منها الاعتراف بالآخر والمساواة في الحقوق والواجبات وتأكيد حرية الرأي والاعتقاد ومنع التمييز بين المرأة والرجل.
لكن كثيرة هي العقبات التي تنتصب في وجه قيام الدولة المدنية في العالم العربي وأولها طبيعة البنى المجتمعية العربية واتصافها بالتعددية الاجتماعية أو شدة التنوع من حيث الانتماءات والعصبيات القبلية والطائفية والعرقية والجهوية، وثانيها التآكل المتواصل لموقع الدولة ودورها من قبل هذه العصبيات، وثالثها غياب الثقافة الديموقراطية أو ضعفها الشديد في المجتمعات العربية لصالح الثقافات الشمولية، ورابعها ضعف المجتمع المدني وغلبة الأهلي على المدني، وخامسها طغيان التخلف المتعدد الجوانب العلمية والفكرية والاقتصادية.
هذه العقبات وغيرها تقف سداً منيعاً أمام قيام الدولة المدنية وتضع التطور الديموقراطي للمجتمعات العربية في مسار متعرج ستظل الصراعات والنزاعات تحكمه لأمد بعيد. لكن لا بد أن تسلك الثقافة الإنسانية طريقها إلى داخل المجتمعات العربية، وتتأسس على قاعدتها ثقافة سياسية متجددة على رغم دروب الشوك العسيرة التي ستسير عليها هذه الثقافة في مجتمعات أدمنت ثقافة الاستبداد على امتداد تاريخها الطويل، وقد أثبتت الانتفاضات العربية استحالة عودة العرب إلى الخضوع لأنظمة الاستبداد والقمع على شاكلة ما حصل في العقود السابقة.
كرم الحلو
حقوق النشر: الحياة 2016